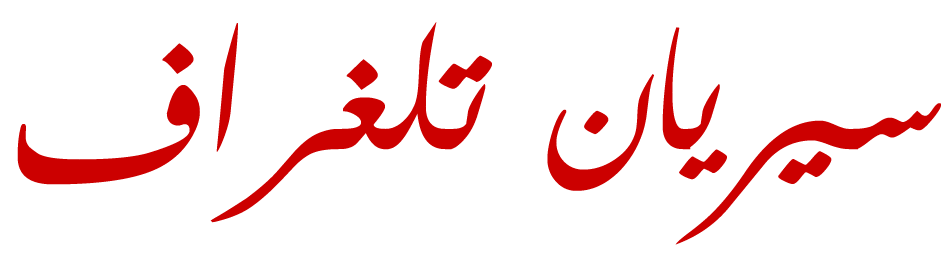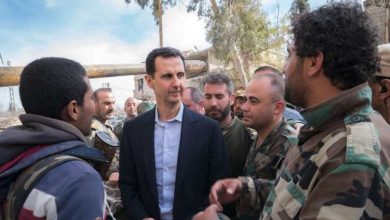السفير : ائتلاف المعارضة السورية يلعب دور “الكومبارس” والكلمــة الأولى للسلاح والدول المموّلة
اشار الكاتب طارق العبد في صحيفة السفير الى ما كتبه ناشط من مدينة حلب على صفحته في موقع «فايسبوك»: «النظام والمعارضة لم يمارسا السياسة منذ أربعين عاماً».
واعتبر ان كلامه ربما يأتي هذا التوصيف واقعياً بشدة، وهو يصف المعارضة السياسية السورية التي تصرّ على التغريد خارج سرب الشارع.
وكأن الشارع السوري قد كُتب عليه أن يعاني ضعف وتشرذم تشكيلات معارضة تسعى لأن تكون بديلاً عن نظام يبدو الرابح الأكبر من انقسام عابر للحدود، في وقت يبدو أن موجة التفاؤل التي عمّت الجمهور المعارض إثر ولادة «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» قد ذهبت أدراج الرياح.

السبب هو أن الائتلاف، حديث الولادة، قد ورث أمراض سلفه المجلس الوطني بأكملها، وبدت علامات المرض واضحة مع تقدمه الزمني، حتى تراجع الأمل به شيئاً فشيئاً.
وهكذا استمر في تكرار أداء المجلس الوطني في الخطاب السياسي والإعلامي، كما في التعاطي مع الشارع والمعارضة المسلحة التي وجهت له ضربة قاصمة بسلسلة البيانات التي رفضت الاعتراف به، والتي أكدت على سعيها للدولة الدينية.
أما الضربة القاصمة التي تلقاها منذ يومين فكانت حين اضطر للاعتراف بـ«جبهة النصرة» كفصيل مقاتل ضمن المعارضة المسلحة رغم الضغوط الغربية التي لم تتوقف لاستبعاد المتطرفين.
ويصل التخبط مداه في العمل على تشكيل حكومة انتقالية، ليغرق في جدل بيزنطي بين الاعتراف أو التشكيل. وفي المحصلة، ما زالت الكلمة الأولى للسلاح وما زال الائتلاف الوليد في غرفة الإنعاش.
وعلى الرغم من التظاهرات التي خرجت وأعلنت دعمها لـ«الائتلاف الوطني»، إلا أن هذا الدعم الشعبي سرعان ما تراجع نتيجة أداء الكيان السياسي الجديد.
ففي الوقت الذي يستمر فيه تدفق اللاجئين على الجوار العراقي والأردني واللبناني والتركي، وفي ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية لتلك المناطق، بالإضافة إلى نازحي الداخل وحضور الفئات المتطرفة في بعض المناطق، خاصة في الشمال، أظهر «الائتلاف» أنه غير مكترث بكل هذا.
في المقابل، استمر يطلب ويشدّد على الاعتراف الدولي كممثل شرعي ووحيد قبل أي خطوة أخرى، بينما أصرّ وزراء الخارجية الأوربيون على الطلب من رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب تقديم خريطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية والأداء السياسي والاقتصادي المستقبلي قبل الاعتراف التام به.
ولكن الخطيب عجز حتى اللحظة عن ملاءمة مثل هذه الشروط، ويضاف إلى عجزه، فقدانه لأي سيطرة على ما يجري في الداخل، أقله على ما يُسمى بـ«المناطق المحررة»، حيث دفعت فوضى السلاح إلى ظهور عصابات ومجموعات تحكم بقوة السلاح، إضافة لسلطة المجموعات السلفية. والأخيرة كانت رفضت الاعتراف به، وأعلنت سعيها لإقامة الدولة الإسلامية، وهو ما بدا أشبه برسالة واضحة إلى التيار المعارض مفادها أن الكلمة على الأرض هي للسلاح وليست للسياسة.
وعلى الرغم مما سبق، استمر «الائتلاف» بالبحث وراء الاعتراف التام طمعاً في استرداد سفارات السلطة في الخارج ومقعدها في الأمم المتحدة.
وهو ما تتردّد بشأنه معظم الدول حتى الآن، في وقت تشترط الدول الباقية تشكيل حكومة انتقالية، فيما تشير الأنباء الواردة من القاهرة، مكان انعقاد اجتماعات الائتلاف، إلى خلافات حادة حول الحقائب الوزارية.
من ناحية ثانية، يقول البعض إن ثمة طرفاً ما يُعرقل تشكيل الحكومة، بل يعرقل عمل «الائتلاف» ككل ويسعى لتحجيمه تمهيداً لاستعادة مكانه السابق، أي «المجلس الوطني» الذي قبل على مضض الدخول في «الائتلاف» بشرط حصوله على أكثرية المقاعد أو ما يمكن تسميته بالثلث المعطل، وبالتالي الانسحاب في أية لحظة وتعطيل عمل الكيان المعارض.
ولعل التخبط وسوء العمل لم يتوقفا عند البحث عن الاعتراف وتعيين ممثلين له، بل تعداه إلى العلاقة مع الشارع.
وذلك في استمرار جدلية حصر التمثيل فيه ودعوة من تبقى من المعارضة للعمل تحت رايته، وباستمرار تقديم الأوهام للشارع الذي بدا واضحاً أنه قد استوعب درس المجلس الوطني.
وعليه تحول الدعم الاجتماعي للشارع من المعارضة السياسية إلى المسلحة، على اعتبار أنها حققت حضوراً على الأرض، على عكس «الائتلاف» الذي ما زال ينأى بنفسه عن توجيه أي نقد أو دعوة للإصلاح أو تقييم الذات.
بل أكثر من ذلك، فقبوله بـ«جبهة النصرة» كفصيل مقاتل، برغم استبعادها من القيادة العسكرية الجديدة، يعني ضعفه أمام الرأي العام المعارض الذي نجحت «النصرة» في المقابل بالاستثمار فيه.
وهو بذلك يسير على خطى المجلس الوطني الذي أحجم عن أي نقد أو توجيه لسلوك ناقص في الشارع، فتحول إلى مردّد لهتافات المتظاهرين، إن لم يزايد عليها.
أما عسكرياً فيبدو من الواضح وجود هوة تتسع يوماً تلو الآخر بين «الائتلاف» المعارض وبين «الجيش الحر» الذي أعلن تشكيل قيادته الموحدة الجديدة، بوساطة قطرية – سعودية في أنطاليا التركية.
وقد حصل ذلك من دون أي حضور لـ«الائتلاف» الذي اكتفى بالترحيب به، واستمر يردد الطلب للسلاح والحظر الجوي والشكوى من تأخر الدعم العربي والدولي، في وقت أعلنت معظم الكتائب المقاتلة أنها لم تعد بحاجة لأحد أو أنها أوجدت ممولها الخاص بها، سواء كأفراد أو مجموعات أو دول تقدم المال والسلاح.
وهذا يعني أن أي هيئة عسكرية ستشكل لاحقاً من «الائتلاف»، بمن فيها وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية، ستكون بلا سلطة فعلية ما دام المال والدعم لا يمر بالتيار المعارض الذي حسم أمره وقرر أنه الممثل الوحيد للمعارضة.
أما الباقون من فئات المعارضة، فهم إما لا حضور لهم أو هم صنيعة النظام، وفق قول بعض أعضاء «المجلس الوطني».
وعلى الرغم من أن دعوات قد وجهت لأعضاء هيئة التنسيق في الداخل لحضور اجتماعات الدوحة في إطار التحضير لإعلان «الائتلاف»، لكن الدعوات قد وصلت بصيغة فردية (حسن عبد العظيم كممثل عن الاتحاد الاشتراكي عبد العزيز الخير كممثل عن العمل الشيوعي عارف دليلة كشخصية مستقلة).
وساعد في حضورهم الإصرار غربي، خاصة الأميركي والفرنسي على ضرورة حضور معارضة الداخل وانضمامها لـ«الائتلاف». وتبقى المشكلة الكبرى متمثلة في أن قرار «الائتلاف» (و»المجلس الوطني» ضمناً) هو قرار من قام بتشكيله، أي القطريين والفرنسيين والأتراك، وهي بطبيعة الحال ليست معضلة أوجدها التيار الوليد بقدر ما هي معضلة أوجدها «المجلس الوطني» قبل عام تقريباً.
كان ذلك حين سعى لتدويل الملف السوري والمطالبة بمختلف أشكال التدخل من حظر جوي أو منطقة عازلة أو تدخل عسكري، وهو ما يعني نقل الحلول المقترحة للخارج ورهن قرار المجلس بقرار الخارج، وبالتالي الإذعان لما تقرره تلك الدول التي أعلنت فشله وفقدان الرجاء منه بعد أن باتت المسافة بينه وبين الشارع والمعارضة الباقية والمسلحين شاسعة للغاية.
وكذلك بعد أن أضاع الوقت بالمؤتمرات والاستعراضات الإعلامية والتصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
وفيما يسير «الائتلاف» على خطى سلفه في تكرار الاجتماعات واللجان والتصريحات، تحدث في الداخل السوري تطورات متسارعة يصعب عليه اللحاق بها، لتصبح صورته ككيان سياسي يلعب دور الكومبارس في المشهد السوري، بينما تحول دور البطولة لحملة السلاح، والأهم لمن خلفهم ممن يوجه ويمول ويسلح المجموعات المقاتلة.
سيريان تلغراف